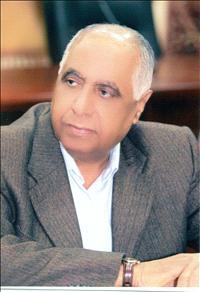لعله مما يثير الاستغراب، ويفجّر الدهشة، تلك الظاهرة الطارئة على مجتمعنا، والتي أصبحت تعكس ثقافة خطيرة
لدى بعض الناس، ونقصد بذلك ظاهرة»اغتيال الشخصية».
هذه الممارسة التي تصل، بموجب الفقه القانوني، إلى درجة الجريمة الكاملة، كونها، أحياناً كثيرة، تفوق عملية الاغتيال المادّي، وذلك لأنها تهدم مقومّات إنسان ما في نظر الآخرين، وتتسبب في سقوط كثير من الاعتبارات له أمام الرأي العام، ويمتد ذلك إلى العديد من أفراد أصوله وفروعه، وهذا أكبر من التصفية الجسديّة، لذا سمّاها علماء الاجتماع والمشتغلون بعلم الجريمة وفقهاء القانون «اغتيال الشخصية». وطالبوا جميعهم بضرورة تغليظ العقوبة على مرتكبيها حتى توازي عقوبات الاغتيال المادي واحياناً نتجاوزه، كون تبعاتها لا تقف عند حد الشخص الفرد بذاته.
وحتى ندرك عظم هذه الجريمة الخطيرة، يجب أن ندرك أن اغتيال الشخصية ربما يطال أحياناً اغتيال شعب بإكمله، واغتيال أمه بجميع مكوّناتها. ولنا في تجربة الشعب الفلسطيني خير مثال على ذلك، فمعظم ما تفعله إسرائيل وحلفاؤها هو محاولات جادّة ومتواصلة لإستئصال هذا الشعب واجتثاته من جذوره الضاربة في أعماق تراب وطنه.
وحتى يتسنى لهم استكمال أطراف هذه الجريمة أخذوا يشوّهون ثقافة الشعب الفلسطيني، ويزوّرون عليه تاريخه، وينكرون عليه صلته بأرضه وبلده. بل أن كثيراً من الطروحات الفاجرة التي قام بها كبار مفكري إسرائيل هو القول بأن
الفلسطينيين قد جاءوا إلى أرض فلسطين محتلين، وأن هذه الأرض هي في الأصل أرض إسرائيل.
وحتى يزيدوا من صلافة جريمتهم فنسبوا هذا العطاء إلى االله وقالوا: إن أرض فلسطين هي أرض الميعاد، أي تلك التي وعدها الخالق إلى بني إسرائيل. ومما زاد الأمر شناعة أمْران: أوّلهما أن العرب والمسلمين هم متقاعصون عن التصدّي لهذه الحرب، وعن مواجهة هذه الجريمة. أما ثانيهما فهو ذلك الإصرار، من قبل الكثير من الجهات الدولية، على مساندة إسرائيل التي بدأت تترجم جريمة اغتيال شخصية الشعب الفلسطيني بطرده من أرضه وبإعلان يهودية دولتها.
ومن مظاهر عملية «اغتيال شخصية» الشعوب والدول هي تشوبه تاريخها وتزويره، وسرقة حضارتها وثقافتها وتراثها.
حتى مقاومة الاحتلال سّمته إسرائيل أرهاباً، وقتلت كل من يطالب بأرضه وداره من الفلسطينيين بتهمة أنهم مجرمون. ومما يثير الاشمئزاز والقلق هو ذلك التصديق الواسع لها في الغربيْن الأميركي والأوروبي اللذين يريان في سلامة إسرائيل (على الرغم من جرائمها) هي سلامة لمصالحهما، وتأميناً لبقاء اليهود خارج أراضيهما.
أما على المستوى الشخصي فإننا بدأنا، للأسف، نمارس ثقافة خطيرة، هي كما قلت، ثقافة «اغتيال الشخصيّة»على مستوى الأفراد، خاصة وأنّ ثورة الاتصالات قد هيأت لهؤلاء المجرمين إجواء واسعة تمثلت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ذهب الكثيرون منهم إلى اعتبار ما يقترفونه من خطايا بأنه حريّة تعبير، إلى أن كشف الفقه القانوني وعلوم الاجتماع والنفس والجريمة أن هذا ليس صحيحا بل وأنه، كما أسلفنا، يفوق في أثاره وتداعياته مستوى الاغتيال المادّي.
وعليه فإننا يجب أن ندرك أنّ اغتيال الشخصية ينطوي، في معظم الأحيان، على المبالغة والتضليل والتلاعب، بل وأكثر من ذلك يعكس جُبْن المجرم، وخوفه من مواجهة الواقع، وضعف شخصيته، وعدم ثقته بنفسه، لذا نراه يوسّع جريمته ويصر عليها.
منذ عام 1930 ،يوم أن أصبحت عبارة»اغتيال الشخصيّة»مصطلحاً متداولاً، والناس تحاول جهدها لمواجهة الأمر الذي اعتبرته جريمة ومرضاً وآفة، بكل الوسائل الفكرية والقانونيّة والجزائية والردعيّة، لأنه في استمرار هذه الجريمة ميلاد مجتمعات مملؤة بالفوضى والكذب والاضطراب والنزاع والصراع.
وفي المطرح الأخير نقف ونقول: إن مقارعتنا لاغتيال الشخصية لا يعني أننا نرفض الرأي الآخر، أو نَحْجُر على عقول الناس، ولكن نريدها عقولاً واعية، ونريدها ضمائر حيّة.
ohhadrami@hotmail.com
الرأي